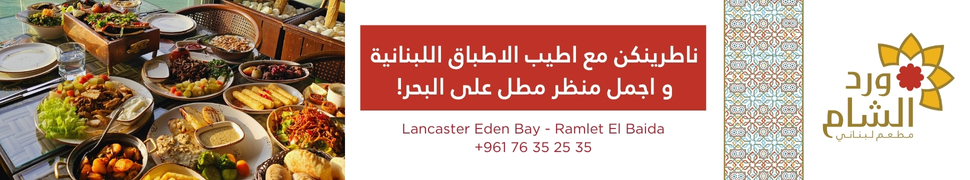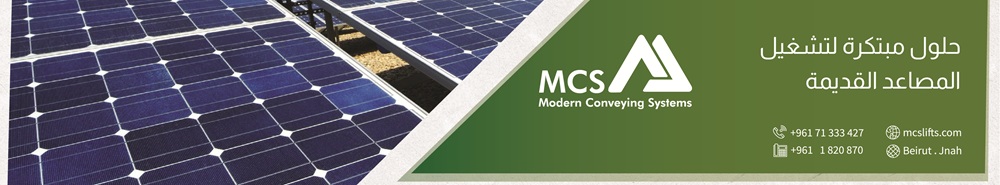| علي فضّة |
قد بدأ عهد جديد. “طوفان الأقصى” أخذنا، على كل المستويات والاختصاصات، إلى أماكن غير تقليدية. التقليد يجعلنا نراوح مكاننا، مهما أنتجنا، حتى إن كان عظيمًا كالسابع من تشرين الأول/أُكتوبر. ولكننا تعودنا على القلق. نعم، نقلق من أي شيء كبير فعلناه، من أي حق أخذناه. ربما مردّ ذلك إلى ما يسميه علم النفس بـ “العقد المجتمعيّة”. تلازمنا تلك العقد، التي يطول شرحها بجوانبها كافّة. نبدأ متحررين من العقد ونحقق إنجازات، ثم تعود تلك المتلازمّة توهن شخصيتنا، ربما لأنّ محاولاتنا التحرريّة فرديّة. نتوه في الخواتيم، كأن العناصر المكونة لشخصيتنا السياسية والمجتمعية ناقصة، أو أنّ جراح الاستعمار والغرق بالاستشراق أثخنونا.. لا ندري! ربما نحن بأمسّ الحاجة إلى طبيب نفسي سياسي، يعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا، ويزيل الندوب من شخصيتنا، ويعيد لهويتنا الحضور ولفكرنا البروز بعد حالة الضمور الجماعي، من الممكن أن يكون التاريخ قدّ وجد ضالتنا، حتى أصبح بإمكاننا القول إن طوفان الأقصى هو ذاك الطبيب النفسي. التاريخ، من ناحية محور المقاومة والفلسطينية منها على وجه الخصوص، قال كلمته: براعة في القتال تراكمية، صمود أسطوري إيماني، صلابة وحنكة تفاوضيّة، فعلوا فعل “تأثير الفراشة” من ناحية سياسيّة عامّة، أضحت عالمية، بحراك شعبي لم يكن موجودًا، حتى بدأ الحديث عن تداعٍ لنظام عالمي كان متسيّداً. لا خلاف مع وجهة النظر هذه، لكن يجب حساب أن يعود هذا النظام البادئ بالتداعي إلى إنتاج نفسه بصيرورة انتقامية، بإصدار أكثر وحشية. لا شيء يمنعه إذا لم نسبقه بخطوة استراتيجية مدروسة بتأنٍ بالغ، وبتحصين أنفسنا ومشروعنا أكثر، داخل حدود “سياسة المعرفة” بفضائها الواسع وخياراتها العلاجية المعرفية المتعددة، من دون الدخول بجدليّة “المعرفة السياسية” و”سياسة المعرفة”، لا سيما بشقهما الحداثي، بحثهما يطول.
“العالم قرية صغيرة”: مقاربة سياسية
مقاربة أن الإنترنت والتكنولوجيا جعلوا العالم قرية كونية صغيرة، صحيح، لكن هل قبل الثورة التكنولوجية، كان العالم عوالم متعددة؟ ليس دقيقًا هذا الكلام، ولا أظن أنها مقاربة حقيقية، نسبيًا. بمعنى سياسي اوضح: هل الجغرافيا السياسية حديثة المنشأ؟ أم أنها تضرب عميقًا في التاريخ السياسي، لا سيما للقوى العظمى التي تغيّرت مع مرور الأزمنّة؟ ربما تطورت الأدوات والآليات، لكن المفهوم ليس بحديث.
لماذا هذه المقاربة الموجزّة؟ للقول إنّ السياسة بالمطلق دائمة التأثّر بالجغرافيا، كما أنّ الجغرافيا مؤثرة بها أيضًا. إنها حالة طردية، وعليها بُنيَت تحالفات، ومن أجلها خيضت حروب، على اختلاف خلفيات تلك الحروب، وتطور مفاهيمها مع أدواتها وصولًا لعصرنا هذا. أما عن جوهرها فهو نفسه، لكنه ابن زمانه ومكانه وثقافته الذين ينتجون بمجملهم الغاية وصياغة التحالفات على أساسها. لم تكن تقاس الحروب بالمسافات بل بالغايات والأهداف. هذه حقائق تاريخية بنيوية في معرفة كبر العالم من صغره. الأهداف لم تكن، ولن تكون، تحدها حدود أو مسافة. الأهداف هي الأهداف، والحروب هي الحروب، والغازي هو الغازي، والمواجه هو المقاوّم، على مساحة الأرض، تجارب نجحت وأخرى فشلت، هكذا سارت الأمور…
إذن، أي مشهدية تأخذ منحى صراع، يجب النظر إليها ككل وليس كجزء، لا سيما في شكلها الجغرافي والسياسي. الجزء في صلب الكل، الكل ليس ترفًا رؤيويًا، بل حاجةً متأصلة في إحداث توازنات، التوازنات ضرورة كينونية لتحصين المنجزات، وعلّة من علّل الإكمال للوصول للغايات، أي الأهداف.
إننا نواجه الغرب، وإن كان مسرح العمليات أرضنا المشرقية. وضدّ الغرب هو الشرق، ذلك بديهي. هنا، يبرز سؤال، لماذا علاقتنا قلقة مع الشرق، سيما أنهم الأقرب من حيث الشبه إلينا؟!
الآن، بعد التمهيد، نحن أمام غرب كولونيالي، وشرق طموح بعد الانكفاء. روسيا والصين، يواجهان الولايات المتحدّة والناتو مِثلنَا، تقريبًا، ومن يظن الصراع مع “إسرائيل” آخر الكيانات الإحلالية الاستيطانية الغربية هو بمعزل عن ما يتشكل في العالم، فقد قارب الخطأ. إذن، ما المانع من السير وفق القاعدة السياسية المعروفة بـ”تقاطع المصالح” مع الشرق، وإشراكهم ـ أقلّه سياسيًا ـ في الوقت الحالي، بدل تفرّد أميركا والغرب الذي يدور في فلكها بالرعايّة وتقديم الضمانات غير المضمونة أساسًا (هنا لا أتحدث عن الدعم المباشر لـ”إسرائيل”). إن للكيان المُحتل عِزوَّة، وكأننا نحن المقطوعين من شجرّة التحالفات. سيقول قائل “روسيا والصين مشغولتان بهمومهما”.. نعم، هم كذلك، وأميركا والناتو مشغولون بهم. إجمالًا القوى العظمى لا تقارب الصراعات من هذه الزاوية الضيّقة، والدليل، فيتوات روسيا والصين في مجلس الأمن بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أسقطت مشاريع الغرب بخصوص الحرب الدائرة حاليًا، وانغماس أميركا بها.
المسألة ليست انشغال، لأنّ الدوّل تقارب هكذا مسائل بمفهوم الأمن القومي، حيث يشخصون الأخطار والتحديات المستقبلية ويبنون سياساتهم على هذا الأساس، بمعزل عن الانشغالات الدائمة، الأمن القومي للدوّل الكبرى خط أحمر عريض.
إذن أين المشكلة؟ ولماذا علاقتنا مع الشرق قلقة؟
المشكلة أننا لم نؤسّس لعلاقة صحية حقيقية مع الشرق، فمثلًا، الاتحاد السوفياتي قبل صعود الصين، كان ورقة ضغط على الأميركي. بمعنى أوضح، كان مطيّة لجذب اهتمام “العم سام” إلينا. أغلب دوّل شرق أسيا، أو الشرق الأوسط، كانوا يستغلون الشرق بحسب ظنهم لنيل رضى الغرب، ولا مانع من الارتماء في أحضان الغرب بعد استغلال الشرق، لهذه الغاية، ويأتي أحدهم قائلًا “لماذا يعاملنا الشرق على القطعة”. أتظنون أن دوّل الشرق الكبرى غبيّة؟ هي لا تأمن لنا جانب، وتجاربنا معها مخزيّة. هم ليسوا ملائكة طبعًا، وأنا لست معجب بستالين ولا بالاتحاد السوفياتي كتجربّة، ولكن سقوط حائط برلين لا يعني إسقاط مبادئي وقناعاتي، أو العبث بقواعد سياسية شَرطيَّة، وتغيير رأيي من شرّ الغرب المتوحش، لكن السياسة هكذا، وإدارة التوازنات ضرورة استراتيجية، ليقول آخر “هل المطلوب فكّ الارتباط مع الغرب؟” الجواب: كلا، ولكن …
هناك تجربة ماثلة أمامنا، أقله نأخذ منها العبر، ونناقشها حيث لا ضرر بذلك. التجربة السوريّة، بارزة أمامنا، سوريا تاريخيًا اختارت معسكرها، دولة شرقيّة، ورغم ذلك لم تحظَ بالدعم الكامل من السوفيات إلّا في عهد يوري إندربوف. هو الوحيد ربما الذي وثق بالرئيس حافظ الأسد وأظهر جذريّة في الصراع بين المعسكر الشرقي والغربي حينها، حيث قدم الأسلحة السوفياتية من دون سقوف. بالفعل فتح إندربوف مخازن “الجيش الأحمر” لسورية، لكنه قال للأسد الأبّ، مقولة بالغة الدلالة “بقدر ما أعطيك من أسلحة، الولايات المتحدّة ستعطي إسرائيل الضعف. اذهب نحو التحالفات السياسيّة، وانسجها بشكل متقن، فهي المحدثة للتوازنات وتحميك”. قبل هذه المرحلة كان حافظ الأسد قد طرح بالفعل مفهوم “التوازن الاستراتيجي”. شرحه، بمقاصده المعرفية، يطول. وثم لاحقًا قال مقولته الشهيرة “أميركا، صداقتها قاتلة وعداوتها مهلكة”. أظنها مقولة فلسفية سياسية، لا ارتجالية سياسية، فهي تعني، أن لا تكون معها داخل ولا خارج، لا متصل ولا منفصل، ثابت عند الضرورة متحرّك عند الحاجة. أميركا، “الوكيلة الشرعية” للغرب، كانت قد بدأت بالتسيّد على العالم، فلم تكن تنفع معاداتها المطلقة ولا وضع كامل عنبك في سلتها. إجمالًا الساسّة الغربيون كانوا دائمي القلق من الأسد، وبنفس الوقت محط إعجابهم. وهنا، بإيجاز، ما تفعله روسيا في سورية حاليًا، ليس إلّا المطلوب، بحدود المعرفة بين الطرفين. في لحظة تاريخية استفاد منها الأسد الابن بالحرب الكونية التي شُنّت عليه، والنتائج بارزة بجوهرها وليس بترهات منتقديها.
الخلاصة: يجب إشراك الشرق بما يجري في منطقتنا حاليًا، ذلك من دون إغفالنا لإكمال الضرورات الاقتصادية والأمنية والعسكرية لاحقًا، ضمن حدود المصلحة الاستراتيجية. فقد جربنا الغرب على مدى عقود، فكنا دائمًا ضحاياه. وفي هذا التوقيت التاريخي بالذات، يجب اغتنام الفرص، بضوابط “السياسة الحكيمة”، فكما قلنا، مقاربة المشهد ككل يحتِّم علينا ذلك، دون اصطفاف علني مُستعجل، بل لتحصين المنجزات ببعد دولي توازني، هو حاليًا مصلحة للشرق ولنا ـ إذا اقتنعوا منا!
ومن جهتنا الرؤيوية، وإذا كنا نريد إحياء شخصية سياسية متينة سمتها الحكمة، قبل اختيار معسكرنا، الذي أراه حتمياً وليس اختيارياً، لأنّ العالم في مرحلة تشكّل جديد، لذا لا يمكننا أن نكون على جانبه، واستشراف المستقبل ليس خياراً، بل حاجّة ملحّة لمواكبة التغيرات والتفاعل معها بتناغم بحدود القناعات.