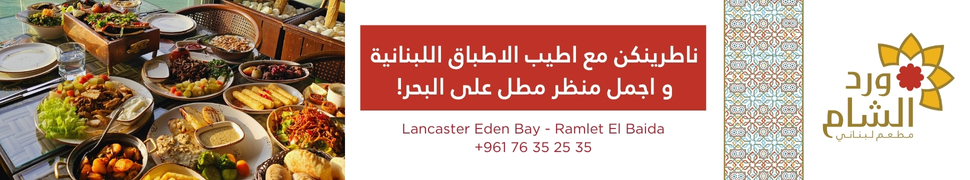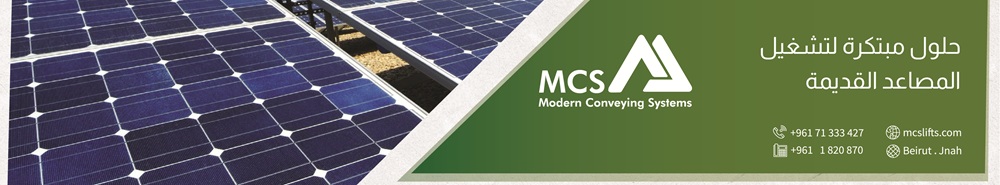| علي فضّة |
إن مقارباتنا هذه تنطلق من واقع الحدث المُعاش ـ حرب غزّة ـ الذي يرتب علينا، لأجله، تقديم مراجعات وتفكيك أحداث تاريخيّة وحالية، لأننا ـ ببساطة القول ـ لا نملك استراتيجية مواجهة فكريّة واضحة، منسجمّة مع التطورات والأحداث، وتتفاعل بتناغم في إنتاجيّة التوعيّة والتأثير الضامن والمحصّن لآليات المواجهة الأخرى المتعددة، كما لا يوجد جذوّة متقدة معياريّة واضحة كنسق أوّل في المواجهة قبل البندقيّة على أهميتها البالغة.
المثقف
المثقَّف هو الشَّخص الملمُّ بالمعلومات والمعارف عن العالم، وحضاراته، وثقافاته، وعلومه، وأعلامه. وهو مشتق من “ثقافة”، فيمكن أن تكون مثقفاً إسلامياً أو سياسيًا أو موسوعيًا، ومثلاً “كوزموبوليتانيًا” – المكان الذي يحوي ثقافات مختلفة ومتعددة – على الطِّراز الحديث. والثَّقافة هي صفة عامَّة ولا تعني الخبرة في مجالٍ معيَّن.
هذا أبسط توصيف لمصطلح “مثقَّف”، لنبدأ التعريف الثقَّافي ـ المثقَّف، بعمقٍ أكبر من أي تبسيط يفقده دوره الأساسّي ووظيفته النقدية غير القابلة لترف اللا اختيار “أي أنه اختار أن لا يختار”، هو أساسًا ليس “كافكا” في عُزلته ولا هو قدّم ما قدمه الأخير في مجاله الفلسفي والمعرفي ـ أي ليس لديه بخل معرفي، بل أدى قسطه للعلى، وفي عزلته أنتج أيضًا. “إنها طبيعة فطرية” للعقل الذي يرفض الراحة ويتريّض دائمًا.
يرى أنطونيو غرامشي أن جميع الأفراد لديهم قدرة على التفكير – هذا من نافل القول، ولكن دور المثقَّف أو المفكّر في المجتمع ليس شأنا يمتاز به الجميع. بالنتيجة رأي الفيلسوف الإيطالي لزمان ومكان محددين، لا يمكننا القول أنهما لا يتماشيان مع ظروف زمكانية مختلفة، لكن أيضًا لا يمكننا تعميمها بوجود مذهب فلسفي كـ “البراكسيس” الذي نحا نحوه “غرامشي” من دون استطاعته تخطيه، فهو ليس من المذاهب الحديثة التي يمكن العبور فوقها، فبروزها الأوّل كان في العصر الكلاسيكي اليوناني ومازال ساريّ المفعول وهو ـ طريقة أو ممارسة يتمُّ من خلالها إنتاج نظريَّة أو درس ما، أو مهارة معينة أو إدراك.
“طوفان الأقصى”
هذا الحدث الجلّل الذي حدث صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان من المفترض أن يشكّل صدمة إيجابية للمثقفين الجديين، رغم أن تداعياته كانت ذات “مهر” غالي، إلّا أنّه كان، مكان تيه للمثقفين الذين تسلل بينهم “المتثقفون” (مثقفو البلاط والأدوار والأقلام الوظيفية) ـ هنا لا أتحدث بمفهوم غرامشي عن “المثقَّف العضوي” أو “المثقَّف التقليدي” ـ الحديث عن “المثقَّف السياسّي”، لأنني لا أريد معالجة ظواهر بل دور من المفترض أن يكون عليه حال المثقَّف، وهو النسق الأوّل للمواجهة، حيث ـ بحسب مفهومي ـ المثقَّف هو جهاز المناعة الأوّل الذي يتصدر للمثقفين الهلاميين المعاديين بشكل صريح على الجبهة الأخرى، والناعقين الوظيفيين خلف أي أجندّة لا تتوافق مع فكرة المقاومّة. “جهاز المناعة” يتعرّف على المخاطر المهددة للمجتمع والأمّة والمشروع، ويقوم بمقاومته فكريًا، بعيدًا عن اصطفافات الردود المعلّبة والكليشيهات المعروفة، دوره بعد مرحلة التصدي، التوعيّة والتأثير على الرأي العام لفهم طبيعة الصراع بكليته، كممر إجباري تكاملي مع المقاومّة المسلحة بمفهومها المطموس بالبروباغندات المُشوِهَة لها، باعتبارهم إياها “حالة ترف سلطوي دموي”، لحرف النظر عن جدواها وضرورتها كحالة انسانيّة تحرريّة، فطرتها الحريّة، ولكشف عدو كالذي تواجهه، العدو الإسرائيلي، يوظّف مبالغ طائلة للدعايّة، ولمشروع قائم لديهم عنوانه “الفوز بمعركة السرديّة”. المقاومة المسلحة تواجه جيوشاً، لكن من ذا الذي سيواجه ” السرديّة”؟ هناك يبدأ المثقَّف بالذهاب عميقًا لتشكيل وعي جماهيري تاريخي، ومحاكاة خيار اللا مقاومّة وتداعياتها، ويسير بخط الاستقراء بسبره أغوار كينونة الصراع.
صراحة، هم قلة الذين يواجهون فكريًا بأسلوب غير نمطي استبصاري تفكيكي، بمفهوم متطور بأحداق المخاطر المتنكرّة. البعض ذهب إلى أنسنة الصراع بكليته باعتباره ناجع كدواء في إيضاح إجرام العدو، لكنهم وقعوا في فخ “التسليع”، ليصبح الشهيد رقم يرتفع كمؤشر البورصة! لكن ما فاتهم أن الأضرار الجانبية لهذا الدواء، لا نبالغ إن قلنا أنها مؤذيّة، لأنّ السؤال عن المسؤول سيضيع بتأويلات الإعلام والأبواق المجيشة للتلميح أنها المقاومة ـ التصريح يضرهم فيكتفون بالتلميح. المثقف يضيء على العدو بشكل مباشر بحججه تفنيدية، لكن قبل أن يبدأ معركته عليه مواجهة “التلسيع” و”التشييء”، ذاك يكون عبر التسييس. صحيح أن القضيّة الفلسطينيّة قضيّة إنسانيّة، لكنها قبل أن تكون كذلك هي سياسيّة، لها أبعاد ووظائف.
أما نوع المثقَّفين السورياليين ومحبي السلام، سأختم معهم بمقطع من كتاب ليو تولستوي في روايته “السلم والحرب”، حيث جاء فيه رد بليغ يحاكي الموضوعية وسيرورة وصيرورة التاريخ.
يقول إن “بيار بيزوخوف، الكاتب المحب للسلم الذي يتلقى الاهانات من كل صوب في مجتمعه لرفضه خوض الحروب والمشاركة فيها على غرار شباب جيله، لكنه بعد غزو نابوليون بلاده، ومشاهدته أهوال ما حدث من حوله، انضم إلى صفوف المقاتلين، وعاش تجربة قاسية بين مشاعره الوطنية وواجبه بالدفاع عن عائلته ومحيطه ومبادئه الرافضة لفكرة القتل”… أي أنه قاتل ضد القتل، وهذه طبيعة الذي يجري، نقاتل ضد القتل، ولاستعادة الأرض والمثقف.
طبعًا وكالعادّة، من دون تعميم.
* الآراء الواردة في المقالات تعبّر عن رأي كاتبها ولا يتحمّل موقع “الجريدة” أي مسؤولية عن مضمونها