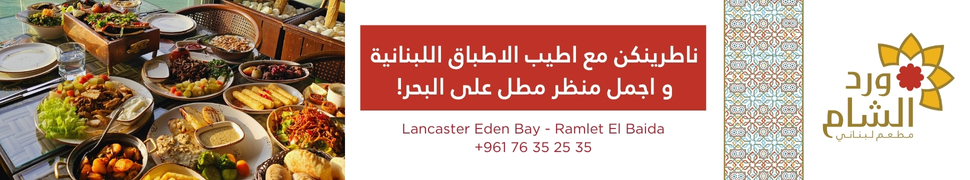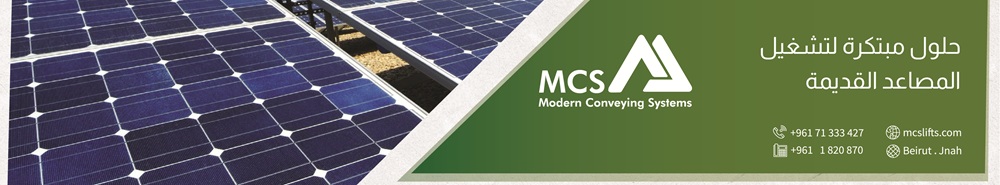| جورج علم |
المعادلة واضحة. كلّ يوم يمرّ من دون إنتخاب رئيس، يعني تكريس أمر واقع جديد على أرض لبنان. لا شيء إسمه الفراغ. وكلّ فارغ يُملأ. والحديث عن الفراغ الرئاسي، يواكبه تنفيذ مخطط دولي يشمل النازحين السوريّين، والمخيمات الفلسطينيّة، والنفط والغاز، والإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، مقابل الفدرلة، أو اللامركزيّة الماليّة الإداريّة الموسّعة.
ويبدو وكأن في الأمر مقايضة. تنفّذ الدول الخارجيّة أجنداتها وتمسك بالمفاصل الرئيسيّة للوطن، مقابل السماح للبنانييّن بنوع من اللامركزيّة الموسعة، أو شكل من أشكال التعددّية ضمن الوحدة.
ويتصدّر الكلام عن اللامركزيّة، اهتمام الجامعات الكبرى، ومراكز الدراسات والأبحاث، ونوعيّات مميّزة من المفكّرين والضالعين في العلوم السياسية. ولكل جامعة، أو نخبة دراستها، أو ما يعرف بمشروعها المتكامل حول الفدرلة الممكنة في لبنان، والمنسجمة إلى حدّ بعيد مع تنوعاته الطائفيّة، الإجتماعيّة.
وليس صحيحاً أننا أمام حفلة زجل حول الفدرلة. أو أمام موضة معروضة في واجهات سياسيّة للفت الأنظار، واستقطاب الذوّاقة. أو أمام صرعة إعلاميّة تواكب الإستحقاق الرئاسي، وتتقدّم عليه في زمن الليرة الجهلانة التي تتعرّى على مسرح الإنهيار. الحقيقة أبعد من ذلك، وما يحاك لـ”لبنان الكبير” بدأ قبل أن يحتفل بمئويته الأولى، ويحتاج إلى سنوات لتنفيذ المخططات. والدليل أن الكلام عن الفدرلة بدأ في حديقة الطائف، وقبل أن يتوصّل المجتمعون يومها، إلى التسوية التي حملت عنوان “إتفاق الطائف”.
وبدأ في قاعات الحوار، سواء في جنيف، أو لوزان، أو سان كلو… وكنت واحداً ضمن مجموعة من الإعلامييّن، لبّت دعوة رسميّة من الحكومة السويسريّة صيف العام 2007، يومها التزمنا ببرنامج محكم الإعداد. كنّا في ساعات الصباح الأولى نستمع إلى محاضرات حول التجربة السويسريّة “التعدديّة ضمن الوحدة”. وفي ساعات ما بعد الظهر نخضع لدورات عملية من خلال زيارات مقرّات برلمانيّة فدراليّة، أو مؤسسات حكوميّة للإطلاع على ما هو لامركزي من صلاحيات، وعلى الأواصر التي تربط ما بين اللامركزي والمركزي، أو ما يعرف بالمؤسسات الرسميّة الضامنة للوحدة، والحامية لسيادة الوطن، ومصالحه العليا. كان الهدف يومها تطعيم المجتمع اللبناني بلقاح اللامركزيّة الموسعة، ويبدو أن مفعوله قد بدأ في المجتمع اللبناني بعد كل تلك السنوات.
وما يغني عن التعريف، أن معظم من يعدّ الدراسات حول اللامركزيّة القابلة للحياة ضمن بيئة المجتمع اللبناني المتنوّع، قد استعان، أو يستعين، بخبراء، أو بدراسات من الخارج، للاهتداء بأصولها وفصولها ومخرّجاتها. ويكاد ما هو متداول من نقاش أن يكون متشابهاً، أو مكمّلاً بعضه للبعض الآخر. إلاّ أن الدراسة التي أعدّها المحامي نبيل منوال يونس، مع شلّة من المفكّرين، كانت مميّزة لجهة التشديد على “المناصفة المسيحيّة ـ الإسلاميّة.
يمهّد المحامي يونس لدراسته بالقول: “يندرج هذا البحث في تصوّر لنظام فدرالي للبنان أقترحه كبديل للنظام المركزي الحالي، الذي أرتقب نهايته لعدم ملاءمته لتعدديّة الهويات الطائفيّة اللبنانية، الناتجة عن التنوّع الإتني والديني والطائفي والحضاري والثقافي واللغوي والقومي والوطني، بحيث فشل النظام خلال أكثر من قرن بتأمين إطار لتعايش المجموعات من جهة، وأسس للسلم الأهلي من جهة أخرى”.
ويؤكد: “بأن المساواة بالمناصفة قد أصبحت قاعدة ناظمة تجسّدت بنصوص وأعراف دستوريّة وقانونيّة وتنظيميّة، وشرطاً لازماً لإبقاء التوازن والتعدديّة في الحكم وتنوّع المجتمع المقيم على مساحة لبنان الكبير، حيث أن إنتفاء أي منهما ستنتج عنه حرب أهليّة تؤدي، لا محالة، إما الى هيمنة ديكتاتوريّة، دستوريّة كانت أم مسلّحة، أو إلى تقسيم لبنان”.
ويعتمد يونس في دراسته على مرتكزات، أهمّها: “التعدديّة اللبنانيّة. الديمقراطيّة في المجتمعات التعدديّة. المساواة والتوازن في لبنان بين المجموعات. تاريخ المناصفة، والمساواة والتوازن في بيروت، في جبل لبنان، في لبنان الكبير. الطائفيّة السياسيّة في إطار المساواة والتوازن في الحكم بين مجموعتين اجتماعيتين. شرط التجانس بين الناخب والمنتخب. المناصفة كقيمة ثابتة وشاملة وعابرة للطوائف. وأخيراً، نتائج إعتماد التوازن والمناصفة”.
وبمعزل عمّا تحوي دراسته من تعب مجبول بعرق البحث عن القواعد القانونيّة والدستوريّة لتمييز بحثه، يبقى شغفه مشدوداً نحو المناصفة، واحترام العرف، والصيغة، والميثاق. قد يجوزّ التغيير في ديكور البيت اللبناني، إلاّ أن العمود الفقري يجب أن يبقى سليماً، وبمنأى عن صواعق التفجير. يمكن أن يخضع النظام لعمليّة تجميل ـ بمعزل عمّا إذا كانت ستنجح، أم لا – لكن الثوابت يجب أن تبقى فوق الأهواء.
المسيحيون اليوم، بغالبيتهم، قلقون من حاضرهم، والمستقبل، والمصير.. يبحثون، بغالبيتهم، عن ضمانة. البعض يجدها باللامركزيّة الموّسعة، أو بنوع من الفدرلة، للهروب من مؤشرات تقلقهم.
العدد يخيفهم. ضمانة الرئيس رفيق الحريري بوقف العدّ ربما أصبحت لدى الغالبيات الأخرى شيئاً من الماضي. عاد العدد، وعاد الحماس لدى البعض الى العدّ.
المسيحيون، بغالبيتهم، مقتنعون بأن “حق العودة” صعب المنال، وأن التوطين الفلسطيني بات أمراً واقعاً، مع ما ينطوي عليه من مخاطر، وتحديات. المسيحيّون، بغالبيتهم، يرون أن دمج النازح ضمن المجتمع المضيف يتحوّل الى أمر واقع بفعل الإرادة الدوليّة، وغياب الإرادة الوطنيّة اللبنانيّة الصلبة الرادعة المانعة. والمسيحيّون بغالبيتهم، يعتبرون أن الإنهيار الحاصل على مختلف المستويات، إنما يستهدف دورهم وحضورهم في الدولة والمؤسسات. لكن هل اللامركزيّة هي الضمانة.. أم الإنصهار الوطني الحقيقي الفاعل؟ وأي لبنان سيبقى من دون هذا الإنصهار الوطني القائم على قوّة المؤسسات، واحترام التوازنات؟!