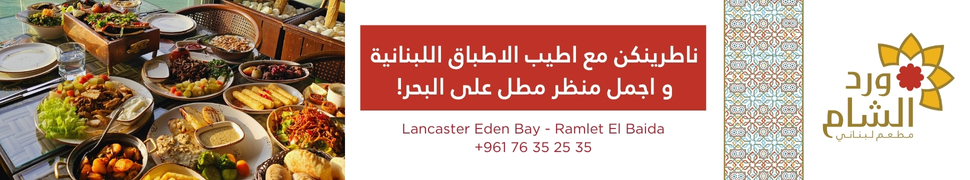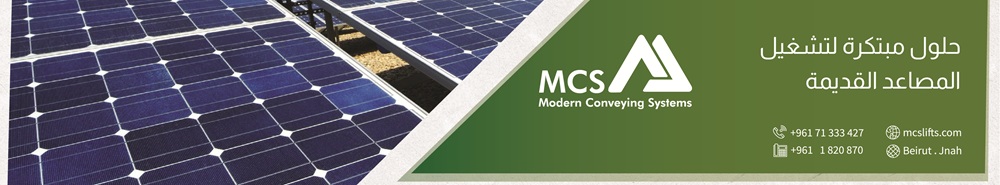/ حوراء زيتون /
ربما، لم يكن “تشانغ كاي تشيك” يُدرك، حين هرب مع بقايا حكومة “الكومنتانغ” (الحزب القومي في الصين)، عام 1949 إلى تايوان، وجعلها مقراً للحكومة زاعماً تمثيلها الصين كلها، أن هذه القضية ستستمر بالتفاعل على مدى عقود، وستشغل الدول العظمى، على اختلاف محاورها، بعد سبعين عاماً.
أو ربما كان يعرف..
وفي كِلا الحالتين، فإن الخلاف مستمرٌ حتى اليوم، والقضية لم تصل بعد إلى حلٍ يرضي الطرفين، ونقصد بالطرفين: الصين، صاحبة أكبر عدد سكان في العالم، بمليار ونصف المليار نسمة، وتايوان، الدولة التي مساحتها 36,197 كم²، وتشكّل جزيرة تايوان 99% من أراضيها.
يفصل الدولتين مضيق تايوان، ولا تتجاوز المسافة بينهما 140 كم.

الصين: جمهوريتان تتنازعان على السلطة
عام 1895، انتصرت اليابان في الحرب الصينية – اليابانية الأولى، واضطرت حكومة تشينغ إلى التنازل عن تايوان لليابان.
وبعد الحرب العالمية الثانية، استسلمت اليابان وتخلت عن السيطرة على الأراضي الصينية التي استولت عليها، لتحكم الصين تايوان بموافقة حلفائها، أميركا وبريطانيا، باعتبارها أحد المنتصرين في الحرب.
بعدها بسنوات اندلعت الحرب الأهلية في الصين، وهزمت قوات ماو تسي تونغ الشيوعية، قوات الزعيم تشيانغ كاي شيك (الوطنية).
وبعد انتصار الشيوعيين على الوطنيين (الكومنتانغ) عام 1949، انسحب جزء من الجيش الصيني بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، حيث أطلق الكومنتانغ عليها اسم “الصين الوطنية”، وزعموا أنهم يمثّلون الصين الموحدة، بينما بدأ الشيوعيون المنتصرون حكم البر الرئيسي، باسم “جمهورية الصين الشعبية”.
وقد قال كلا الجانبين إنهما يمثلان الصين كلها.
ومنذ ذلك الحين تسعى الصين إلى إعادة السيطرة على تايوان.
في خضم تلك الأحداث، ظنت أميركا أن تايوان ستسقط عاجلاً أم آجلاً في أيدي الشيوعيين، ما دفعها للتخلي عن مساندة “الكومنتانج” والانتظار حتى تتضح الأمور.
وفي ما بعد، وحين اتضح العكس، ونظراً لظروف الحرب الباردة، قرر الرئيس الأميركي هاري ترومان، التدخل وإرسال الأسطول الأميركي السابع إلى مضيق تايوان، لحماية الجزيرة ومنع شيوعيي بر الصين الأساسي من بسط سيطرتهم على الجزيرة.
في العام 1952 دخلت معاهدة “سان فرانسيسكو”، تليها معاهدة “تايببه”، قيد التنفيذ، واللتان قضيتا باعتراف اليابان رسمياً بتايوان كجمهورية الصين. غير أن أميركا وبريطانيا قد اختلفتا في ما بينهما على إذا ما كانت جمهورية الصين (تايوان) هي الوريث الشرعي لجمهورية الصين الأولى، أم جمهورية الصين الشعبية، ما أدى إلى تجميد المعاهدات بشأن الاعتراف بأحقية أي طرف في السيطرة على الجزيرة.
في ما بعد، ونتيجةً للحرب الباردة، اعترفت أميركا والعديد من الدول الغربية الأخرى بجمهورية الصين (تايوان) كممثلٍ شرعيٍ وحيدٍ لجمهورية الصين الأولى، وأقرّت بعدم شرعية حكومة جمهورية الصين الشعبية (البر الأساسي).
وفي العام 1971، قررت أميركا انتهاج سياسة انفراج في علاقتها مع جمهورية الصين الشعبية، أدت إلى صدور قرار لهيئة الأمم المتحدة، قضى بأحقية جمهورية الصين الشعبية بمقعد جمهورية الصين الأولى، وطرد جمهورية الصين (تايوان) من مجلس الأمن وإعطاء مقعدها لجمهورية الصين الشعبية.
وفي العام 1979 قامت أميركا بقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بينهما. وحتى اليوم، لا تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.
تايوان الحديثة ـ أميركا: مدّ جسور.. وسياسة “الغموض الاستراتيجي”
في العام 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، جرى اتصال بين رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عُرِف بـ “مكالمة ترامب ـ تساي”.
المكالمة، التي تخلّلها “تبادل تهانٍ” بين تساي وترامب المنتخبَين حديثاً آنذاك، وُصِفَت بالخطوة “غير المسبوقة”، وأحدثت ضجةً واحتجاجاً من الجانب الصيني، الذي اعتبر حينها أن المكالمة “عمل تافه” من قِبَل تايوان.
أميركا، وعلى الرغم من تأييدها للاعتراف بالصين الشعبية كممثلٍ وحيدٍ للصين، إلا أنها كانت وما زالت تعترض على التعامل مع الأراضي التايوانية، على أنها أراضٍ صينية، وهذه تُعتبَر نقطة خلافٍ بين الصين وأميركا، تستغلها الأخيرة كورقة ضغطٍ على الصين بين الحي والآخر.
تحفّظات أميركا الكثيرة بشأن اعتبار تايوان جزءاً من الصين، تعمّقت بصورة أكبر منذ تنصيب دونالد ترامب كرئيسٍ لها.
ترامب، أدرك جيدًا أهمية تايوان الاستراتيجية بالنسبة للصين، لذا سعى إلى تعزيز سبل التعاون مع حكومتها، كنوع من “المكايدة” السياسية للخصم الاقتصادي اللدود.
وفي آذار من العام 2018 وقّع ترامب على قانون السفر لتايوان، الذي يدعو إلى إجراء زيارات على مستوى أعلى بين البلدين.
ومن ثم بدأت التحركات الأميركية لدعم القدرات التسليحية لتايوان، وهذا ما أثار حفيظة وقلق الصين، وأدى إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين (الصين وأميركا).
في الأيام الأخيرة لعهد الرئيس ترامب، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنه تقرر رفع القيود عن التواصل بين مسؤولي أميركا، ونظرائهم في تايوان.
الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، بدوره أكمل سلسلة “الانقلاب” على سياسة أميركا المتّبعة منذ عقود، ليثير الجدل في تصريحٍ له، في إحدى المقابلات التلفزيونية أواخر العام 2021، قال فيه إن “أميركا لن تتوان عن الدفاع عن تايوان”، في حال تعرّضها لهجومٍ من قِبَل الصين.
حينها ردّت الصين بدعوة واشنطن إلى “التصرف بحذر بخصوص تايون”، متوعدةً أنّه “لا مجال لديها للمرونة في القضية”.
بايدن كرّر تصريحه “المثير” وبلهجةٍ أشدّ، مرّةً ثانية، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في العاصمة طوكيو.
ورد بايدن على سؤالٍ حول ما إذا كانت أميركا ستتدخل عسكرياً، ضد محاولة صينية للسيطرة على تايوان بالقوة، قائلاً: “هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا”. وأضاف: “كنا موافقين على سياسة صين واحدة (…) ولكن فكرة أن تؤخذ تايوان بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة”.
الصين شددت في ردودها المستنكرة لتصريحات الجانب الأميركي، على أنّ “قضية تايوان شأن داخلي محض بالنسبة للصين”. محذّرةً من أنها في “القضايا المتعلقة بالسيادة ووحدة الأراضي، ليس لديها مجال للتسوية أو التنازل”.
وحينها اتجهت الأنظار للمباحثات التجارية وخطط التعاون الاقتصادي بين أميركا وتايوان، لا سيما بعد تصريحات رئيسة تايوان تساي إينج وين، إثر لقائها السيناتور الأميركية تامي داكويرث، وكلامها عن “تعاون أوثَق وأعمق بين تايوان والولايات المتحدة في مسائل الأمن الإقليمي”.
مؤخّراً، رفعت الصين حدة خطابها وتحذيراتها، بعد أنباء عن نية رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، زيارة تايوان خلال الأسابيع المقبلة، وحذّرت من أنها “ستتخذ الإجراءات الحاسمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، إذا استمرت الولايات المتحدة في تصرفاتها الحالية”.
بيلوسي رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانت ستسافر إلى الجزيرة أم لا، معتبرةً في الوقت عينه على أنه “من المهم لأميركا أن تُظهر دعما لتايوان”.
ورداً على سؤالٍ بشأن هذه الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى الجزيرة قال بايدن إن “الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة”، مضيفاً: “لكني لا أعرف أين نحن”.
المواجهة العسكرية مُستَبعدة
يستبعد مدير موقع “الصين بعيون عربية” علي محمود ريّا، ذهاب الأمور نحو مواجهة عسكرية بين الصين وتايوان.
وفي حديثٍ لـ”الجريدة”، اعتبر ريّا أن أميركا تهدف “لتحجيم وتأطير” الصين، وهي تحاول الضغط على الصين من خلال زيادة العلاقات التجارية مع تايوان، ومحاصرتها إقليمياً، عبر الضغط على العديد من الدول المجاورة للصين، للانضمام إلى الاتفاقية الأميركية الجددية المرتبطة بالمحيطين الهادئ والهندي. إضافةً إلى الضغط عليها في بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
ورأى ريّا أن “الصين لن تتجه لعملٍ عسكري في تايوان، إلا في حال أعلنت تايوان استقلالها الرسمي والكلّي، واعترفت دول العالم بهذا الاستقلال”، لافتاً إلى أنه طالما بقيَ الموضوع ضمن إطار “الضغوط” والمحادثات الاستراتجية، فلا مواجهة عسكرية.
وعن تشابه المشهد التايواني مع المشهد الأوكراني، قال إن “المشهدين متقاربان”؛ ولكن الفارق يكمن في أن روسيا وأوكرانيا كلاهما دولتان مستقلتان، “بينما تايوان كانت وستبقى جزءاً من الأراضي الصينية، والخلاف بينهما داخليٌ بحت، وتدخّل أميركا هو تدخّل في الشؤون الداخلية الصينية”.
وعود واشنطن: ضغوطٌ على الصين.. وخطوات غير محسوبة
الجيش الصيني، ومنذ إعلان تصريحات بايدن الأخيرة، زاد نشاطاته العسكرية قرب جزيرة تايوان، كتحذيرٍ لأميركا. في الوقت الذي تصرّ فيه واشنطن على تأكيد موقفها “غير الداعم” لاستقلال تايوان، وثباتها على سياسة “الغموض الاستراتيجي”.
فإما أن يكون الهدف هو “الضغط” على الصين ومحاصرتها، أو أن واشنطن تحاول حفظ “خط عودة”، لا سيما وأنها تدرك أن الصين ليست عدواً سهلاً (عسكرياً كما اقتصادياً)، وهي ـ الصين ـ لا “تتهاون” في الرد على أي تهديدٍ موجّهٍ لها.
وليست تجربة أوكرانيا ببعيدة، فواشنطن التي أغرقت أوكرانيا بالوعود وروسيا بالتهديدات، تمارس “مواجهتها” من بعيد، ومن خلف خط أمانٍ يحفظ لها فرصة التراجع في أي لحظةٍ تتغيّر فيها التوازانات، أو تتبدّل فيها أولويات مصالحها.
ويُلتَمسُ تقارب المشهدين (الأوكراني والتايواني) بقوّة، من ناحية العلاقات مع أميركا.
فهل توصِلُ واشنطن باستفزازاتها تايوان إلى مصير مواجهةٍ عسكريةٍ غير متكافئةٍ مع الصين؟ أم أنّها تمارسُ ضغوطها على الصين لكسب ملفاتٍ ليس إلّا؟
بجميع الحالات، يبدو أن واشنطن لا تُمسِك زمام الأمور بتعقّل، ولا يُستَبعَدُ الانفجار الفجائي في مشهد الصين ـ تايوان. والمؤكّد أن خواتيم “المناكفات” الدائرة حالياً، تقع في قبضة التنين الصيني، لا طرف آخر.