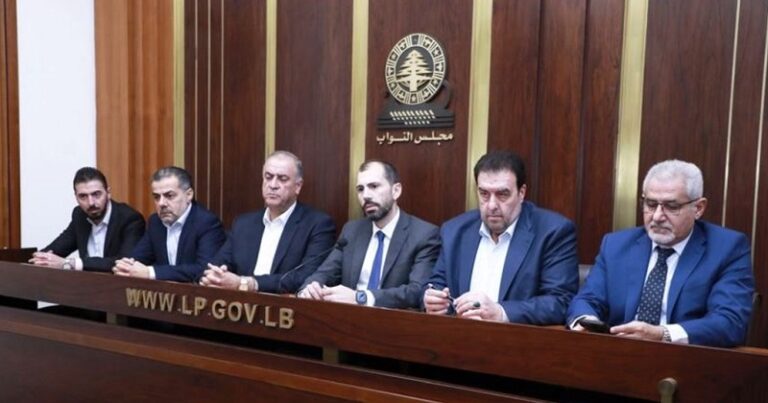ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على الممثل الشهير جان يمان والفنانة سيلين جورجوزيل وعائشة ساغلام وجيرين ألبير، في إطار تحقيقات موسعة بتهمة التورط في قضايا “مخدرات”.
وقاد هذه العملية الأمنية الدقيقة، مكتب تحقيقات مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية، في نيابة إسطنبول لضبط المشاهير المتورطين في ترويج وتعاطي المخدرات.
وتم التحفظ على الأسماء المذكورة لإخضاعهم للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم ضمن نطاق القضية.
بدورها، دهمت فرق الجندرما (الدرك) “فندق بيبك” الشهير في منطقة بشيكتاش، بالإضافة إلى عدد من المرافق الترفيهية المعروفة في المنطقة.
كما شهدت العملية استنفارا أمنيا مكثفا لجمع الأدلة والبحث عن ممنوعات داخل المواقع المستهدفة.
وقد استمرت العملية لعدة ساعات قبل أن تنسحب القوات الأمنية فور انتهاء المهام الميدانية، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية في الأيام القادمة.
وانطلقت التحقيقات مطلع تشرين الأول 2025، في تهم تتعلق بـ”تعاطي المواد المخدرة” طالت مجموعة كبيرة من المشاهير في مجالي الفن والإعلام والمجتمع التركي.