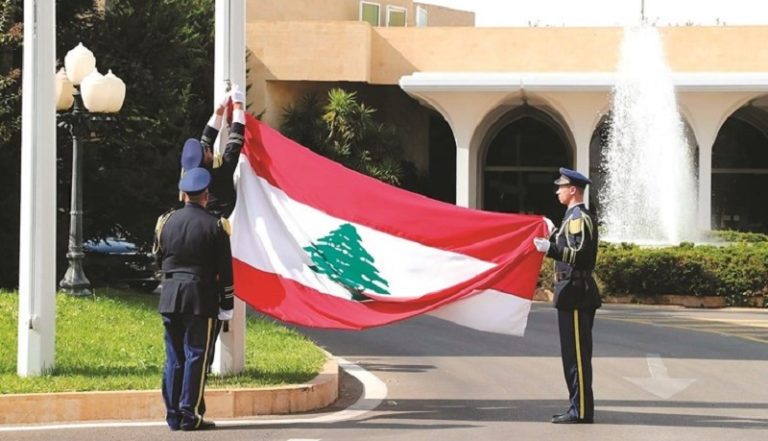| ابراهيم الأمين |
لا أُحجيات مع القاتل الكبير، ولا أسئلة تستدعي منجّمين أو ضاربي رمل. فالصورة في غاية الوضوح، بل لعلّها الأوضح في تاريخنا الحديث: هناك مجرم يقود عصابة عابرة للحدود، يعلن منطقه بلا مواربة: أنا ربّكم الأعلى، وما أريده عليكم تنفيذه. إن فعلتم سلماً منحْتُكم حياة العبيد، وإن رفضتم قتلتُكم وأبَدتُ نسلكم.
في مواجهة هذا الوحش، ينقسم الناس. فريق غير قليل يرى أن النجاة تمرّ عبر الإذعان لمطالبه، مع تعلّقٍ بوهم تغيّرٍ ما في زمنٍ لاحق. في المقابل، قلّة تدرك أن ما يُطرح ليس بحثاً عن تسوية، بل مشروع قتل شامل، سواء وقفنا مرفوعي الرأس أو زاحفين تحت الأرض. ولهؤلاء منطقهم الواضح: فلنقاوم، ولنحرمه شرط الاستسلام، وهناك أمل بأن مقاومة الوحش قادرة على إحداث التغيير الكبير.
أنصار الاستسلام ينطلقون من التسليم بالهزيمة قبل إطلاق الرصاصة الأولى، بحجّة أن قوة الوحش لا تُضاهى. وهم، في العادة، يميلون إلى القوي ويعجبون به ولو كان قاتلاً، رغم أن التاريخ يثبت أنهم جرّبوا هذا الخيار قروناً طويلة، ولم ينجُ منه إلا قلّة تحوّلت اليوم إلى أدوات جباية لمصلحة الوحش نفسه.
أمّا الفريق الآخر، فليس واهماً ولا فاقداً للعقل. بل يعرف أن التاريخ يعلّم الشعوب أن المقاومة القائمة على المعرفة والقدرة والإرادة قادرة على تخريب أخطر المشاريع. ألم تسقط إمبراطوريات عاشت قروناً تحت ضغط المقاومة؟ ألم تخسر أوروبا المتوحّشة معظم نفوذها في أقل من قرن بسبب مقاومات جدّية؟ ألم تنتهِ حروب أميركا في مطلع هذه الألفية بخسائر فادحة أصابت مشروعها من أفريقيا إلى الخليج والعراق وأفغانستان؟ كل ذلك لم يكن ثمرة ذكاء المستسلمين، بل نتيجة مقاومة ذكية.
سيخرج من يقول إن أميركا، حين كانت تخسر، كانت تخلّف الفوضى خلفها. وهذا صحيح. لكنّ الصحيح أيضاً أنها لم تكن تتوقف عن الحرب، بل كانت تنقلها إلى مسافات أبعد. أليس الحصار الاقتصادي، وسياسات القتل بالنار أو بالوباء أو بالتجويع، شكلاً من أشكال الحروب المفتوحة؟ إنها أدوات أخرى يملكها الوحش ذاته، الذي لا يقيم وزناً لأيّ قواعد أخلاقية، ويجاهر بذلك علناً، كما يفعل سيّد وحوش عصرنا، دونالد ترامب.
في بلادنا ومنطقتنا، ثمّة من يجلس مترقّباً نصيبه من المسلسل المفتوح للوحش. وهنا أيضاً، توجد غالبية تدعو إلى الاستسلام، وتهلّل للوحش ظنّاً منها أن في ذلك ما يرفع من شأنها، كأنها لا ترى ما يجري اليوم من حروب «صغار الوحوش» في الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا وشرقها.
في المقابل، توجد في بلادنا أقلية مقتنعة ومنخرطة في مشروع مقاومة هذا الوحش. أقلية تعرف جيداً أنها كلما تقدّمت، انضمّ إليها كثيرون من أولئك الذين يرزحون اليوم تحت وطأة الخوف على حياتهم.
علي أيّ حال، لن يكون النقاش في الخيارات الكبرى مُجدِياً هنا. لكن ما ينفع، وهو ضروري للجميع، إدراك أن ليس في بلادنا من يملك القدرة على فرض رؤيته على الآخرين قسراً. في حالتنا، يمكن للجميع أن يواصلوا صراعاتهم حول الوجهة وطريقة التصرّف، غير أنّ هذا الجدل كلّه يتبدّد في لحظة واحدة، لأن قرار الحرب ليس بيد أيٍّ منا اليوم، بل هو حصراً بيد الوحش نفسه؛ ذلك الوحش الذي لا يشبع من الحروب، لأنه لا يكتفي بما راكمه من ثروات وقدرات، بل يريد كل شيء.
وحين تكون الحرب محكومة بإرادة الوحش، يصبح السؤال الحقيقي المطروح أمام الناس المنقسمين حول الخيار الأنسب سؤالاً وجودياً. فلا يمكن لمن اختار الاستسلام أن يفرض خياره على الآخرين؛ وإذا حاول فرضه، فلن يجد من يسانده سوى الوحش ذاته، فهو الطرف الوحيد المستعدّ لتقديم «المساعدة».
في المقابل، من يختار المقاومة لا ينتظر عوناً من أحد. هكذا علّمتنا تجارب لبنان مع الاحتلال، إذ لم يقف العالم يوماً إلى جانبنا ما دامت لذلك كلفة كبيرة. لذلك، من يقرّر المقاومة يدرك مُسبقاً أنه سيُجبر على تحمّل الأثمان وحده، وأن عليه في الوقت نفسه أن يأخذ في الاعتبار عدم جرّ الجميع إلى دفع الثمن المباشر لخيار المقاومة. وهذا تحديداً ما دأبت عليه المقاومة في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي. فأيّ ضرر أصاب البلاد عموماً كان سببه الاحتلال والحصار من قبل الأميركي، لا خيار المقاومة بحدّ ذاته. لا لأن هذا الخيار بلا كلفة، بل لأن المقاومة ليست الطرف القادر على شنّ الحروب أو فرض الحصار. كل ما تفعله هو مقاومة هذا الوحش: لأنها تجيد قراءة التاريخ، ولأنها ببساطة ترفض الاستسلام، ولأنها فهمت أن القتل سيكون عقابها سواء وقفت منتصبة أم ركعت، لكنها تعرف أيضاً أن لديها فرصة حقيقية لإفشال أهداف الوحش، وفتح نافذة أمل تتيح لمن بقي من أهلها أن يعيشوا حياة أفضل.
المثير للشفقة في لبنان هو مشهد أولئك الذين يهلّلون للعدوان الأميركي على فنزويلا، وهم أنفسهم من هلّلوا سابقاً للعدوان على إيران والعراق وسوريا، بل وعلى لبنان نفسه. يرفعون الكؤوس ابتهاجاً، متمنّين نجاح الوحش في القضاء على كل من يرونه خصماً لهم، فيما يعجزون اليوم، أو لا يجرؤون، أو لا يملكون حتى الحق الأخلاقي، على إعلان موقف واضح من الصراع القائم بين السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ ذلك الصراع العسكري الذي يدور على أرض دولة ثالثة اسمها اليمن.
أليس هؤلاء الصامتون أنفسهم هم من كانوا يعلون أصواتهم اعتراضاً عندما أرسل حزب الله من يساعد ثلثي الشعب اليمني في مواجهة العدوان الذي نفّذه المتصارعان السعودي – الإماراتي؟ أم أن حفنة من الخبراء، قادهم الشهيد البطل هيثم الطبطبائي في اليمن، تشكّل خطراً على اليمن وأهله، وعلى لبنان والمنطقة، أكثر مما تشكّله جيوش جرّارة من المرتزقة تقودها السعودية والإمارات في تلك المنطقة؟
مرة جديدة، لا جدوى من النقاش مع الخائفين من الوحش في كل مكان. وغبيّ، أو «مسطول»، من يواصل الحديث عن القوانين الدولية وسيادة الدول وحقوق الإنسان. النقاش الوحيد المُتاح أمامنا اليوم هو سؤال أنفسنا: هل أعددنا أنفسنا بما يكفي للحرب الآتية بكل نيرانها، أم أننا بتنا قادرين على مباغتة العدو من دون الحاجة إلى انتظاره؟