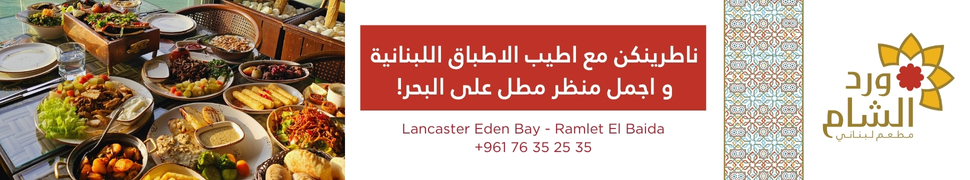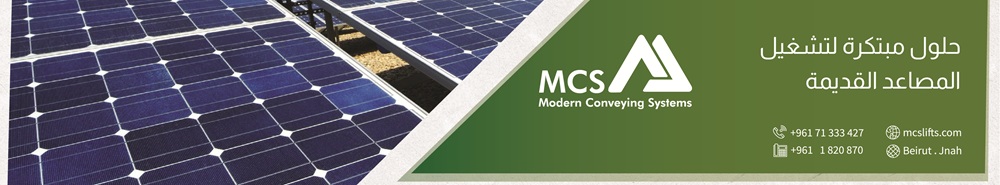| راجانا حمية |
لم تعد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات محصورة بسوء الأوضاع المعيشية أو باستثنائهم من الخدمات العامة، بل ازداد الثقل ليطاول صحتهم مع الانحدار المستمرّ في الخدمات التي كانت تقدّمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وإذا كان كثيرون منهم «تأقلموا» مع فكرة الانعزال داخل كيلومتراتهم المربّعة والاكتفاء بما يسدّ «جوعتهم»، كما يقولون، إلا أن ما لا طاقة على تحمّله هو تدهور صحّتهم التي أصبحت في دائرة الخطر بسبب انعدام التوازن بين أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وما تقدّمه وكالة «الأونروا» من جهة أخرى.
وليست الأزمة المالية الاقتصادية التي تمرّ فيها البلاد منذ عام 2019 السبب الوحيد الذي أدّى إلى تلك الفجوة، بل يمكن إضافة سبب آخر يتعلق بتغيير السياسة الصحية التي تصوغها إدارة الصحة في الوكالة التي تتأثر بقيمة ما تقدّمه الدول المانحة. لذلك، تراجعت المساعدات والمساهمات لـ«الأونروا» بعدما أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها التي كانت تشكّل ما نسبته 30% من موازنة الوكالة، علماً أن لا موازنة محدّدة لـ«الأونروا»، بل تخضع لما تساهم به الدول المانحة، فكلما خفّت المساهمات، تقلّصت الخدمات وبالعكس.
وانعكس الشحّ في المساهمات «ترشيداً» في الخدمات المقدّمة، ومنها الصحية، علماً أن ملامح هذا التدهور بدأت منذ عام 2010، مع «جسّ النبض» الذي قامت به الوكالة عندما أعلنت خفض التغطية الاستشفائية إلى 60%، تُسدّد على أساس تعرفة وزارة الصحة. وكانت هناك معضلة أخرى تتعلق بفوارق التعرفة بين المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوكالة ووزارة الصحة، ما كان يضاعف من قيمة الفروقات التي يجب على المريض دفعها. وفي عام 2016 «حدّثت» الوكالة السياسة الصحية، وأضافت إليها شقاً يتعلّق بـ«مساهمة المريض»، أو ما سُمي بـ»patient share»، بحيث لم تعد نسبة الـ60% ثابتة في التغطية الاستشفائية، وتراجعت إلى 30% في بعض الحالات.
يومها، ووجهت تلك السياسة بإضرابات متنقّلة امتدّت لستة أشهر، تمكّن خلالها المتابعون للملف الصحي من انتزاع قرار من الوكالة يقضي برفع التغطية إلى 90%، مقابل أن يدفع المريض 10% في المستشفيات الحكومية ومؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني.
سارت الأمور على تلك الوتيرة إلى أن حلّت الأزمة المالية، وتراجعت الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية مع الغلاء الذي لحق بكل شيء، وانعكس ذلك على المستشفيات الخاصة التي رفض معظمها التعاقد مع «الأونروا»، خصوصاً في بيروت. وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أنه «باستثناء مستشفى الرسول الأعظم الذي لم تتعاقد معه الوكالة لاعتبارات سياسية، لم يقبل سوى مستشفى خاص واحد في بيروت (الساحل) بالتعاقد مع الوكالة».
ورغم أن قائمة المستشفيات التي تتعاقد معها الوكالة تتوسّع أكثر في المناطق، إلا أن غالبية هذه المستشفيات تتعامل مع المريض وكأن لا عقد موجود، إذ «تطلب من المريض دفع تأمين قبل الدخول، على أن تعيد له ما يدفعه عندما تدفع الوكالة للمستشفى».
أما بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، فتلك معضلة أخرى، إذ إن سقف ما يمكن أن تساهم به الوكالة «هو 500 دولار، فيما يتكفّل المريض بالباقي ولو وصل المبلغ إلى عشرات آلاف الدولارات». أما حالات الطوارئ، فمن دون سقف ولا تخضع تالياً لمساهمة الأونروا، ولذلك، الدفع هنا غالباً ما يكون على حساب المريض. وإن كان الفلسطينيون يلجؤون إلى المساعدة من الضمان الصحي الفلسطيني، إلا أن هذه المساعدة لا تفي بالغرض، ولذلك يكبر اليوم مصطلح «اللميّة»، حيث يتعاون الناس لتأمين فروقات العلاجات أو العمليات.
وثمة أزمة أخرى يعانيها هؤلاء تتعلق بمرضى غسيل الكُلى، إذ لا يوجد مستشفى في بيروت يستقبل هذه الحالات، والمكان الأقرب لمرضى الكُلى في مخيمات بيروت هو مستشفى الهمشري في صيدا، مع ما يعنيه ذلك من كلفة، خصوصاً أن الكثير من المرضى يحتاجون إلى علاج يتخطى ثلاثة أيام في الأسبوع. أما بالنسبة إلى مرضى السرطان، فيخضع هؤلاء في علاجاتهم لسقف حدّدته «الأونروا» سابقاً بثمانية آلاف دولار، وارتفع إلى 12 ألفاً ثم 16 ألفاً. غير أن هذا لا يكفي لأكثر من نصف كلفة العلاج في أحسن الأحوال، ما يضطر المريض إلى استكمال مشواره وحيداً.
وانسحب هذا التقليص في الخدمات على الأطباء والممرضين، إذ تتّبع اليوم الوكالة سياسة جديدة مع هؤلاء قائمة على اعتبارهم مياومين، فتدفع لهم الأجرة «ع القطعة» وليس على أساس عقد بين الطرفين، ما ينعكس عدم استقرار لدى هؤلاء.