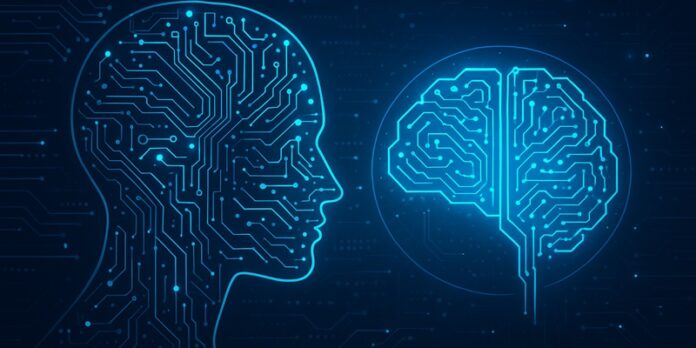| فيصل طالب | (*)

يا له من زمن! الضجيج فيه يعتلي منصّة الحياة، والأضواء تُستبدل بالمعاني، والمحتوى الترفيهي بالمحتوى المعرفي، والمظهر بالجوهر، والاختصار بالتعمّق، والصورة بالإنجاز، والواجهة بالمضمون، والحواشي بالمتون، والأقنعة بالوجوه، والصدى بالصوت، والخواء بالامتلاء، والانكشاف بالخصوصية، والاستعراض بالكفاءة والموهبة، والتواصل”الاجتماعي” بالتواصل الإنساني، وقياس النجاح بعدد المتابعين، وليس بعدد الأفكار التي أضافت جديداً، أو كان لها فعل النفع والتغيير في إحدى زوايا الواقع المعيش.
في هذا الزمان الذي لا تقف تحوّلاته الثقافية عند حد، تتوثّق العلاقة بين العصر الرقمي وظاهرة “التسطيح” والضحالة والتفاهة، والتي تتكفّل، بكل مندرجاتها، بإعادة تشكيل التفكير؛ بحيث يُضعف الاعتماد والاعتياد على “المعلّبات المعرفية السريعة” القدرةَ على التركيز العميق، وممارسة التحليل النقدي، وبذل الجهد الفكري، من خلال جعل المعرفة سلعة استهلاكية تستهدف الإشباع المعرفي البسيط والفوري والمنقطع عن سياقه النصّي العميق، مع أولوية تفوّق الصورة على النص، ولو كان خلفها فراغ مثقل باللهاث وراء الظهور بلا عنوان، لأنّ الغاية صارت ما يُعرض لا ما يُبنى، وما يستجدي التصفيق لا ما يستدعي التصديق، ولأنّ المحتوى غير النصّي يشكّل النسخة الأكثر لمعاناً، لا الأكثر صدقاً؛ ممّا يؤدّي إلى تفاعل أوسع معه، وانتشار أكبر له، ويجعل من النماذج السطحية نماذج مسيطرة تواري المحتوى الجاد والعميق؛ لأنّ سرعة الوسائط الرقمية التي تنقل المعلومات بسرعة الضوء تقود إلى الاختزال، والاختزال يفضي إلى “التسطيح”. السرعة عدوّة العمق، والعمق يحتاج إلى متسع من الوقت، والوقت لم يعد متاحاً دائماً. أضف إلى ذلك أن التدفّق المستمر للمحتوى الرقمي (إشعارات، فيديوهات، صور، قصص…) يفضي إلى حالة من التشتّت العقلي بعيداً من بناء الأفكار الكبرى. إن العصر الرقمي لا يصنع بحدّ ذاته السطحية، بل إنّ استخدام تقنياته بلا بوصلة يؤدّي إلى الإسهام في انتشارها، ومكافأة منتجيها، وإضعاف القدرة على مقاومتها.
ولعلّ أخطر ما يتّصف به عالم اليوم في هذا السياق هو تلك الفجوة الهائلة بين غزارة الاتصال التقني والعزلة العاطفية (التواصل الرقمي محل الأحاديث الوجاهية، والإعجابات محل العناق)، وبين الفيض المعلوماتي والغيض التمحيصي والتأملي لتحويل المعلومات إلى فهم عميق للحياة، وبين الانفتاح الافتراضي والانغلاق الاجتماعي، وبين الحاضر (الاتجاه والصيحة Trend) والمستقبل (التخطيط والاستدامة)، وبين الحرية الظاهرية والاستعباد الاستهلاكي. إنه عالم يمنحنا كل الإجابات، لكنه يسرق منّا الأسئلة الكبيرة التي تعطي الحياة الإنسانية قيمتها الحقيقية. ليس هذا فحسب، بل إنّ الذكاء الاصطناعي أضاف إلى تلك الفجوة طبقات جديدة أكثر عمقاً، وتحدّيات عديدة أهمّها:
- التحدّيات الأخلاقية التي تتجلّى بتجاوز الخصوصية الفردية واستخراج معلومات حسّاسة من البيانات المستخدمة، وأنظمة التعرّف على الوجوه والمراقبة، وعدم القدرة على التدقيق الأخلاقي في النماذج الخوارزمية التي تعمل كصندوق أسود، وتوليد محتويات مضلّلة كتزوير النصوص والصور والفيديوهات والأصوات…
- التحدًّيات الإنسانية التي تظهر في تراجع التفكير النقدي والتحليلي والإبداعي، وإضعاف المهارات البشرية، وتقليص دور الإنسان في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار. وفوق كل ذلك، فإن المقارنة المتواصلة بين قدرات الإنسان والآلة، معطوفة على العزلة الرقمية، قد تزيد من عوامل الاضطراب والقلق لديه.
- التحدّيات الاقتصادية التي تتمثل بفقدان الوظائف وازدياد البطالة، وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات يصعب اكتسابها بسرعة، واتساع الفجوات بين المؤسسات والدول، من خلال قدرة شركات تكنولوجية عملاقة على امتلاك الذكاء الاصطناعي وتطويره، وتحقيق أرباح هائلة في هذا النطاق، في غياب هذه القدرات والإمكانات لدى آخرين؛ فضلاً عن تقويض حقوق الملكية الفكرية بمؤدّاها التقليدي.
إن الاستجابة لهذه التحدّيات يحتاج الى حوكمة رشيدة، وتشريعات حافظة، وتعليم آمن مستمر، كي يضمن الإنسان استفادته من هذه الثورة العلمية الهائلة.
إن وعي القيم التي تغيب، كما التي تبرز، هو بداية الطريق لإعادة التوازن بين حاجاتنا العميقة ومتطلبات العصر؛ ولن يكون ذلك إِلَّا من طريقين: إدراك فردي وجهد جماعي، بنهج واقعي متدرّج. فعلى المستوى الفردي لا بدّ من تمارين التقشف الرقمي واقتطاع أوقات من يومياتنا بلا شاشات أو اتصال بشبكة الإنترنت، لصالح مساحات من الحوار المباشر، وإعادة الاعتبار للقراءة المتعمّقة، والاستماع الى الموسيقى، وممارسة الرياضة والهوايات، والإنصات الى الطبيعة، واسترجاع القدرة على التأمل، وتحديد أوقات للروابط الأسرية والأصدقاء، ومراجعة ما سبق أن تعلّمناه، وطرح أسئلة على أنفسنا مثل: ماذا نريد أن نتذكر من حياتنا بعد سنوات، أو من نكون عندما لا يرانا أحد، أو هل نفعل هذا لأننا نريده فعلاً، أم لأنّ الجميع يفعلونه؟ أو هل هذه المشاركة تضيف شيئاً مهماً، أم هي فقط لتثبت أنّنا موجودون؟…
إن الأساس في هذا المسار هو وعي استخدام التكنولوجيا، وتوظيفها للتعلّم والاطلاع والبحث وتيسير تنفيذ المهام، بدلاً من السماح لها باستهلاك الوقت والطاقة بما لا يفيد؛ الأمر الذي يقتضي معه استثمار الجهد في العلاقات االحقيقية غير الافتراضية، والتمسّك بمبادئ تحفظ توازن المرء في خضمّ هذا الضباب الرقمي الكثيف، كأن يستعيد المرء دائماً ما يؤمن به، حتى لا يبتعد عنه مع مرور الوقت، ويستحضر كلّ ما يربطه بوجوده الحيّ، حتى تبقى قوّة الإيمان بما يعتقد قادرة على تجديد حمايته من الانجراف في تيارات العصر التي تأخذه من ذاته، وترميه في ضباب التشتت والضياع والاستنزاف، وعلى إعادة تعريف قيمته الذاتية التي تأتي من تأثيره الإيجابي فيمن حوله، ومن تعميق علاقاته الاجتماعية، والتركيز على ما يمتلك في حياته الحقيقية من نعم تقوّي شعوره بالرضا الداخلي، لتنتفي معه الحاجة إلى استعراض ما يفتقده. إنّ الحياة التي نعيشها في الإطار الواقعي أكثر صدقاً وثراءً من تلك التي تستعرضنا تعويضاً عمّا ينقصنا، وتمويهاً لفراغ يعترينا.
إن التوازن المطلوب في هذا الإطار لا يعني البتة رفضاً لموجبات العصر ومقتضياته، بل إقامة علاقة أكثر وعياً معه؛ بحيث نتمكّن من استخدام التكنولوجيا دون أن تستخدمنا، ونكون في قلب العالم الرقمي من غير أن نفقد عالمنا الإنساني، ونتماشى مع الزمن من دون أن نضيّع بوصلتنا الداخلية، وذلك كي لا يأخذنا الصدى بعيداً من صوتنا الأصيل، ولا يطغى الصخب على همسنا الخفيض. إنّنا نحتاج، بين متطلبات أرواحنا المتمهّلة ومقتضيات عصر متعجّل في كل شيء، إلى أن تكون جذورنا عميقة في أرض القيم الإنسانية، وعقولنا مؤتلفة مع أدوات العصر، لبناء أشياء لهـا معنى؛ وذلك عندما نأخذ منه ما يفيدنا، ثم نعود الى داخلنا كي نحتفظ بشرارة الدفء التي لا تعكسها سوى شاشة النفس، لا شاشات التكنولوجيا. وكأنّنا في هذا الرواح، خارج النفس وداخلها، نمشي على خيط رفيع يمتد بين ضجيج الخارج وهمس الداخل. وحين ننجح في هذا العبور ندرك أنّ ما يضيء في الداخل أصدق ممّا يلمع في الخارج، وأن طاقة هذه التوازن المنشود هي حركة في عمق الروح، تتشكل عندما تخبط على جدرانها ضوضاء تعكّر صفو انشغالها بالبحث عن ألق الإنسان الذي ترتاح في كنفه، أو عندما يسقط على سطحها الرقيق مطر صاخب، فتبحث عن زاوية مطمئنة تلجأ إليها لتخفّف اضطرابها، وتنجو من عالم مزدحم بالسرعة والوجوه العجلى والأفكار العائمة على سطح الحقيقة، لتنصرف فقط إلى ما يمسّ أعماقها، وتتذكّر أنّ ما يبقى لا يأتي على بساط الريح، ولا يتحقّق إلّا بانتزاعه عنوةً من بين الشوائب والمعوّقات، كجوهرة خفيّة لا يعرف قدرها غير من جهد في العثور عليها.